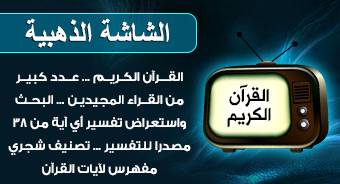|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المشهور بـ «تفسير الألوسي»
والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتال ولم يعبروا به لأن ألسنتهم لكمال تثبط قلوبهم عنه لا تساعدهم على الإفصاح به، وإما الذهاب مع المؤمنين مطلقًا سواء كان للقتال أو للدفع وتكثير السواد وحمله على امتثال الأمر أي لو كنا نعلم قتالًا لامتثلنا أمركم لا يخلو عن بعد.{هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمان} أي هم يوم إذ قالوا لو نعلم إلخ أقرب للكفر منهم قبل ذلك لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاء. والظروف كلها في المشهور عند المعربين متعلقة بأقرب ومن قواعدهم أنه لا يتعلق حرفا جر، أو ظرفان عنى تعلق واحد إلا في ثلاث صور: إحداها: أن يتعلق أحدهمابه مطلقًا ثم يتعلق به الآخر بعد تقييده بالأول، وثانيتها: أن يكون الثاني تابعًا للأول ببدلية ونحوها، وثالثتها: أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل والمفضول الذي يجعله نزلة تعدد المتعلق كما في المقيد والمطلق، وما نحن فيه من هذا القبيل كأنه قيل قربهم من الكفر يزيد على قربهم من الإيمان، واللام الجارة في الموضعين عنى إلى بناءًا على ما قيل: إن صلة القرب تكون من وإلى لا غير، تقول: قرب منه وإليه، ولا تقول له، أو على حالها بناءًا على ما في الدر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد يتعدى بثلاثة أحرف اللام وإلى ومن، وقيل: إن أقرب هنا من القرب بفتح الراء وهو طلب الماء ومنه القارب لسفينته، وليلة القرب أي الورود، والمعنى هم أطلب للكفر وحينئذ يتعدى باللام اتفاقًا. وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير هم لأجل كفرهم يومئذ أقرب من الكافرين منهم من المؤمنين لأجل إيمانهم، ولا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه لمزيد بعده وركاكة نظمه لو صرح بما حذف فيه.وجوز أن يقدر في الكلام مضاف وهو أهل، واللام متعلقة بتمييز محذوف وهو نصرة والمعنى هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخذالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلًا للمؤمنين، وهذا كما تقول: أنا لزيد أشدّ ضربًا مني لعمرو، وأنت تعلم أنه يمكن تعلق اللام بالتمييز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضًا، وادعى الواحدي أن في الآية دليلًا على أن الآتي بكلمة التوحيد لا يكفر لأنه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم.وقال الحسن: إذا قال الله تعالى: {أَقْرَبُ} فهو لليقين بأنهم مشركون ولا يخفى أن الآية كالصريح في كفرهم لكنهم مع هذا لا يستحقون أن يعاملوا بذلك معاملة الكفار ولعله لأمر آخر.{يَقُولُونَ بأفواههم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} جملة مستأنفة مبينة لحالهم مطلقًا لا في ذلك اليوم فقط ولذا فصلت، وقيل: حال من ضمير أقرب وتقييد القول بالأفواه إما بيان لأنه كلام لفظي لا نفسي، وإما تأكيد على حدّ {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: 38] والمراد أنهم يظهرون خلاف ما يضمرون؛ وقال شيخ الإسلام: «إن ذكر الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم لباطنهم وإن ما عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر في اللسان تارة وفي القلب أخرى، فالمثبت والمنفي متحدان ذاتًا وصفة وإن اختلفا مظهرًا، وإما القول الملفوظ فقط فالمنفي حينئذ منشؤه الذي لا ينفك عنه القول أصلًا، وإنما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال، والمعنى يتفوهون بقول لا وجود له أو لمنشئه في قلوبهم أصلًا من الأباطيل التي من جملتها ما حكى عنهم آنفًا فإنهم أظهروا فيه أمرين ليس في قلوبهم شيء منهما، أحدهما: عدم العلم بالقتال والآخر: الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيهما كذبًا بيّنًا حيث كانوا عالمين به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد»، واختار بعضهم كون {مَا} عبارة عن القول الملفوظ، ومعنى كونه ليس في قلوبهم أنه غير معتقد لهم ولا متصور عندهم إلا كتصور زوجية الثلاثة مثلًا والحكم عام؛ ويدخل فيه حكم ما تفوهوا به من مجموع القضية الشرطية لا خصوص المقدم فقط ولا خصوص التالي فقط ولا الأمران معًا دون الهيئة الاجتماعية المعتبرة في القضية ولعل ما ذكره الشيخ أولى.{والله أَعْلَمُ بما يَكْتُمُونَ} زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم بما يخالف أقوالهم من فنون الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقها، والمراد أعلم من المؤمنين لأنه تعالى يعلمه مفصلًا بعلم واجب، والمؤمنون يعلمونه مجملًا بأمارات، ويجوز أن تكون الجملة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم النفاق، وأن المراد أعلم منهم لأن الله تعالى يعلم نتيجة أسرارهم وآمالهم.
بجر حاتم بدلًا من ضمير جوده لأن القوافي مجرورة. والمعنى يقولون بأفواه الذين قالوا، أو يقولون بأفواههم ما ليس في قلوب الذين قالوا، والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله: والقائل كما قال السدي وغيره هو عبد الله بن أبيّ وأصحابه، وقد قالوا ذلك في يوم أحد {لإخوانهم} أي لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا في ذلك اليوم، والمراد لذوي قرابتهم أو لمن هو من جنسهم {وَقَعَدُواْ} حال من ضمير قالوا وقد مرادة أي قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذال، وجوز أن يكون معطوفًا على الصلة فيكون معترضًا بين قالوا ومعمولها وهو قوله تعالى: {لَوْ أَطَاعُونَا} أي في ترك القتال {مَا قُتِلُوا} كما لم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلوا، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن السدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبيّ في ثلثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه وقالوا له: {لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاتبعناكم} [آل عمران: 167] قالوا له: ولئن أطعتنا لترجعن معنا فذكر الله تعالى نعي قولهم لئن أطعتنا لترجعن معنا بقوله سبحانه: {الذين قَالُواْ} إلخ، وبعضهم حمل القعود على ما استصوبه ابن أبيّ عند المشاورة من المقاومة بالمدينة ابتداءًا وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به ولا يخلو عن شيء بل قال مولانا شيخ الإسلام: يرده كون الجملة حالية فإنها لتعيين ما فيه العصيان والمخالفة مع أن ابن أبيّ ليس من القاعدين فيها بذلك المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة بإخوانهم ينادي باختصاص الأمر أيضًا بهم فيستحيل أن يحمل على ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم عند المشاورة.{قُلْ} يا محمد تبكيتًا لهم وإظهارًا لكذبهم. {فَادْرَءوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ} أي فادفعوا عنها ذلك وهو جواب لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: {إِن كُنتُمْ صادقين} عليه كما أنه شرط حذف جوابه لدلالة {فَادْرَءوا} عليه، ومن جوز تقدم الجواب لم يحتج لما ذكر؛ ومتعلق الصدق هو ما تضمنه قولهم من أن سبب نجاتهم القعود عن القتال، والمراد أن ما ادعيتموه سبب النجاة ليس ستقيم ولو فرض استقامته فليس فيد، أما الأول: فلأن أسباب النجاة كثيرة غايته أن القعود والنجاة وجدا معًا وهو لا يدل على السببية، وأما الثاني: فلأن المهروب عنه بالذات هو الموت الذي القتل أحد أسبابه فإن صح ما ذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فإن أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء، وأنفسكم أعز عليكم وأمرها أهمّ لديكم، وقيل: متعلق الصدق ما صرح به من قولهم: {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين، وحينئذ يكون {فَادْرَءوا} إلخ استهزاءًا بهم أي إن كنتم رجالًا دفاعين لأسباب الموت فادرءوا جميع أسبابه حتى لا تموتوا كما درأتم بزعمكم هذا السبب الخاص، وفي الكشاف «روي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعون منافقًا» بعدد من قتل بأحد.
|